رام الله 20-7-2024 وفا- تنشر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، تقريرا أعدته وكالة الأنباء العمانية ضمن نشرتها الثقافية، بعنوان: " تحت سماء موسكو، يروي "بهاء الفضة" حكاية إبداع عُماني أصيل"، هذا نصه:
على وقع أنغام التاريخ العريق، تُشرع أبواب متاحف الكرملين في موسكو لاحتضان معرض "بهاء الفضة: مقتنيات من البلاط العُماني". رحلةٌ عبر الزمن، تُجسّد عبق الحضارة العُمانية، وتُبرز إبداع الإنسان العُماني في صياغة الفضة وتحويلها إلى روائع فنية تتحدّى الزمن.
يُقام هذا المعرض الفريد تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة في روسيا الاتحادية أولغا ليوبيموفا، ليُجسّد عمق الروابط الثقافية بين عُمان وروسيا. وبهذه المناسبة، تُؤكد صاحبةُ السُّمو السّيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد، مساعدة رئيس جامعة السُّلطان قابوس للتعاون الدولي ونائبة رئيسة مجلس أمناء المتحف الوطني، على أهمية هذه الروابط في تعزيز التفاهم والتعاون بين البلدين.
يُتيح المعرض الذي يستمر حتى 29 سبتمبر المقبل للزائر فرصة استكشاف إبداع الحرفيين العُمانيين في صياغة الفضة، حيث يعرض مجموعة مختارة من المقتنيات النادرة التي تعود لسلاطين عُمان في مسقط وزنجبار. وتُجسّد هذه المقتنيات ثراء الأناقة في التاريخ العُماني، وتُعبّر عن لغة الفن العالمية التي تتجاوز الحدود.
ينقسم المعرض إلى خمسة أقسام رئيسة، وهي: الخنجر العُماني، وثقافة الطيب، وفن صناعة الفضة، والأزياء التقليدية، وأزياء النخبة لشخصيات عُمانية بارزة في شرق أفريقيا آنذاك.
ويبين قسم الخنجر العُماني تطوره عبر التاريخ حيث تم استخدامه منذ الألف الثالثة قبل الميلاد، ويركز القسم على أبرز متعلقات الخنجر، بالإضافة إلى أنواع الخناجر العُمانية كالخنجر السعيدي، وهو عبارة عن مزيجِ من المقبض الرمَّاني المزيَّن وتخريمٍ زينيٍّ كثيف وتركيبة غمد تتألف من سبع حلقات، بالإضافة إلى الخنجر النزواني والصوري وغيرها.
أما قسم ثقافة الطيب فيركز على الروائح الزكية وقيمتها في تفاصيل الحياة اليومية للعُمانيين، والمناسبات واستقبال وتوديع الضيوف، ومن المقتنيات التي يضمها القسم: قنينات عطرية تعود لعام (١٩٨٣م) مصنوعة من البلور والذهب (عيار ٢٤ قيراطا).
ويضم قسم صناعة الفضة على المشغولات الفضية من الحلي، أما قسم الأزياء التقليدية فيبين وظائف الأزياء العُمانية، إذ لا يقتصر زي المرأة على اللبس بل يشمل طقم الرأس والجواهر والبراقع وأدوات التجميل، أما زي الرجل فهو عملي، ويتكون من إبزيم، وحزام، وعدة ملاقط، وأسلحة مزينة بالفضة ومنها الخنجر.
يُعدّ هذا المعرض بمثابة جسرٍ ثقافيٍّ بين عُمان وروسيا، يُعزّز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين. كما يُتيح للمواطن الروسي فرصة التعرف على عُمق الحضارة العُمانية وثرائها، ويُسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين. معرض "بهاء الفضة": ليس مجرد عرضٍ لقطعٍ أثرية، بل هو رحلةٌ عبر الزمن، وحكايةٌ تُروى بلسان الفضة عن إبداعٍ عُمانيٍّ أصيل، يزخر بالجمال والأناقة.
ولاية صور: حكاية أمواج تتراقص على أنامل الحرفيين
تُحاكي شواطئ صور حكاية حضارة عريقة، حكاية أمواج تتراقص على أنامل الحرفيين، حكاية سفن خشبية شاهقة تشقّ عباب الماء، حاملة معها عبق التاريخ وعبق التجارة وعبق عُمان.
منذ فجر التاريخ، اتخذت صور مكانة متميزة في صناعة السفن، فكانت مهدًا للملاحة البحرية ومركزًا إشعاعيًّا لصناعة السفن الشراعية التي جابت أصقاع العالم، تاركة وراءها إرثًا عريقًا يشهد على براعة أبناء عُمان ومهارتهم الفائقة.
لم تكن صناعة السفن في صور مجرد حرفة عادية، بل كانت فنًا يتوارثه الأجيال، فنًّا يمزج بين الخبرة والدقة والإبداع؛ فبأدوات بسيطة ومهارات متوارثة تمكنّ حرفيو صور من بناء سفن ضخمة تراوحت حمولتها بين 100 و250 طنًّا، قادرة على خوض عباب المحيط الهندي دون خوف أو وجل.
وما زاد من روعة هذه السفن هو بناؤها دون الاعتماد على مخططات مرسومة، بل كانت تُبنى بدقة متناهية بفضل خبرة بناة السفن الذين توارثوا أسرار هذه الحرفة جيلًا بعد جيل.
وخلال القرنين التاسع عشر والعشرين، ازدهرت صناعة السفن في صور بشكلٍ ملاحظ، لتصبح من أهم مراكز هذه الصناعة في الجزيرة العربية.
وازدادت شهرة صور بصفته مركزًا تجاريًّا بحريًّا مهمًّا، إذ كانت سفنها تبحر إلى أنحاء العالم، حاملة معها بضائع عُمان من تمور ولبان وعطور وغيرها.
وللسفن الخشبية مواصفات تميز الواحدة عن الأخرى، من حيث الشكل والحجم وغرض الاستخدام والحمولة ومن السفن التي كانت تصنع في صور سفن "الغنجة" التي اشتهرت مدينة صور بصناعتها، وتعد من أجمل السفن التجارية وأكبرها حجما، فمقدمة الغنجة مائلة يعلوها رأس بشكل قرص دائري، مع حلقات متساوية المركز، ثم تاج في أعلى المقدمة، أما مؤخرتها فتتجلى فيها إبداعات النجار العُماني من خلال النقش على الخشب، كما يظهر في القوس النصف دائري المسمى (الشانده)، وكذلك النوافذ الخمس المقصورة الدبوسة، أما ذراع الدفة فمثبت من الأسفل. وللغنجة صاريان كبيران ترفع عليهما الأشرعة، وتتراوح حمولتها بين ۱۰۰ - ۳۰۰طن.
وهناك أيضا"السنبوج" وهي من سفن النقل التجارية العُمانية الكبيرة، وتوازي سفن الغنجة من حيث الحجم إلى حد ما وهي ذات مقدمة منحنية، يعلوها طرف عريض مدبب، أما مؤخرتها فعريضة مربعة الشكل ولا شك أن الأسطول البحري العُماني كان معظم سفنه من الغنجة والسنبوح، حيث كانت تبحر بأشرعتها إلى الساحل الغربي للهند والساحل الشرقي لأفريقيا واليمن وبحر عُمان والخليج العربي، في رحلات تجارية تستغرق حوالي تسعة أشهر من كل عام.
ومن السفن أيضا "البدن" التي تعد من أقدم السفن العُمانية، وهي صغير الحجم نسبيا ويطلق عليها أحيانا (بدن عويسي) وكانتتستخدم في صيد الأسماك والتجارة البحرية، وخاصة إلى اليمن والساحل الشرقي لأفريقيا، أما الأنواع الأصغر من سفن البدن فكانت تستعمل في النقل الساحلي حول الساحل العُماني، وتتميز "البدن" بمقدمة معطوفة ومؤخرة قائمة، ويبحر باستخدام الشراع والمجاديف.
وهناك أيضا "البوم" التي تعد اليوم من أشهر السفن التجارية في دولة الكويت خاصة ودول الخليج العربي عامة، ولكن صناعته في سلطنة عُمان بدأت متأخرة، وبالتحديد في بداية العقد السادس من القرن العشرين (١٩٥٣م)، وتتميز "البوم" بأنها مائلة المقدمة والمؤخرة وأهم ما يميزها السنام المستطيل في أعلى المقدمة، وتتراوح حمولة البوم بين ۱۰۰ - ٤٥٠ طنًّا، كما أن صناعتها أسهل من صناعة سفن الغنجة والسنبوج.
وإضافة إلى السفن الكبيرة، كان يصنع في صور سفن صغيرة منها "الجالبوت" وهي سفينة تجارية صغيرة الحجم إذا ما قيست بسفن الغنجة والسنبوج، وكانت أعدادها قليلة، ومقدمة الجالبوت قائمة وتنتهي بطرف عريض ولا توجد في الجالبوت لمسات جمالية إلا نادرا، واستخدم هذا النوع من السفن في النقل البحري الساحلي وتتراوح حمولة سفينة الجالبوت بين ۱۰ - ۱۰۰طن.
كما تم تصنع "الماشوة" وهو القارب المرافق لسفينة الشحن الكبيرة، وهذا القارب متوسط الحجم يتم تحريكه بالمجاديف التي لا يقل عددها عن أربعة ولا يزيد على عشرين مجدافًا، وتستخدم "الماشوة" حلقةَ وصل بين السفينة والشاطيء، وكلما كانت السفينة بعيدة عن الشاطئ يتوجب استخدام الماشوة لنقل البحارة والركاب والبضائع ومواد الإعاشة والنوخذة من وإلى السفينة، وإذا أبحرت السفينة ربطت الماشوة خلفها، أما إذا كانت الرحلة طويلة فلا بد من رفعها على سطح السفينة تحاشيا لغرقها وفقدانها.
كما اشتهرت صور أيضا بصناعة سفن الصيد؛ حيث شاع استخدام "هوري الصد" على امتداد السواحل العمانية، وكان الأصلح نظرا لكبر حجمه واستيعابه عددًا أكبر من الصيادين، وقدرته على الإبحار وسط الأمواج ولمسافات أبعد وحمل كمية أكبر من الأسماك حيث يصل طوله إلى 8 أمتار تقريبا وارتفاعه ١،٥ متر، وعدد بحارته بين ٤ - ٦ أفراد، يستخدمون المجاديف والشراع في الرياح المناسبة.
ويعد قارب الصيد هذا في أصله قاربًا محفورًا يستورد من "الملبار" بالهند ويتم محليا زيادة ارتفاعه بالألواح والمسامير وتشكيل مقدمته ومؤخرته المتشابهتين.
كما ظهر أيضا في ذلك الوقت "هوري اخر" وهو هوري العبور، الذي يعد قاربًا صغيرًا محفورًا يستورد من الملبار (الهند) ولا يزيد طوله على 5 أمتار وارتفاعه ٨٠ سنتيمترا وكانت الحاجة إليه ماسة لخفته وسهولة تسييره بمجداف واحد أو اثنين، كما يمكنه نقل 4 أفراد للعبور من شاطئ إلى آخر أو من سفينة إلى أخرى أو لرحلة صيد قصيرة، وبالرغم من الاستغناء عن القوارب الخشبية إلا أن هذا القارب لا يزال يشاهد مبحرا للصيد أو للتسلية أو للسباق في الوقت الحاضر.
ومع تغير العالم إثر الثورة الصناعية وظهور السفن الحديثة التي تعمل بالبخار والديزل، والتغيرات في أنماط التجارة العالمية؛ بدأ نجم صناعة السفن التقليدية بالأفول، تاركًا وراءه إرثًا عريقًا وحكايات خالدة.
ومع ذلك، تبقى صناعة السفن في صور رمزًا لحضارة عُمان العريقة، وشعبها المبدع، وإبداعهم في التكيف مع ظروف البيئة والبحر؛ فصناعة السفن ليست مجرد حرفة تقليدية، بل قصة إنسانية تروي حكاية شعب عشق البحر، وتحدى الأمواج، وبنى حضارة عظيمة.
صدور كتاب "أمثال فارسية وأمثال عُمانية"
صدر عن مجلس النشر العلميّ بجامعة السُّلطان قابوس كتابٌ علميٌّ محكّم بعنوان: "أمثال فارسية وأمثال عُمانية، ترجمة وموازاة ودراسات"، لعدد من الباحثين وهم: أ.د. إحسان بن صادق اللواتي، ود. زاهر بن مرهون الداودي، ود. سناء بنت طاهر الجمالية، ود. فاطمة كريمي.
واشتمل الكتاب على بابين، الأول، ترجمة لمجموعة من الأمثال الفارسيّة المتخيّرة المرتّبة ألفبائيًّا من لغتها الفارسية الأصلية إلى العربية، مع ذكر الأمثال العُمانية الموازية المتفقة أو المتشابهة معها في معانيها.
أما الباب الثاني ففيه دراسات كتبها الباحثون الأربعة المشتركون في الكتاب، ففي الدراسة الأولى المعنونة بـ "نظرة إلى الأمثال بوصفها ثقافة عالمية" تناولت د. فاطمة كريمي الأمثال على أنها مرآة تعكس مزاج الشعب وفكره ومعتقداته وقيمه الأخلاقية والتربوية والاجتماعية، ورأت فيها عاملًا مهمًّا من عوامل التقريب والتعايش السلمي والتفاهم بين شعوب العالم، وقد قارنت في نهايتها بين بعض الأمثال المشتركة في اللغات: العربية والفارسية والتركية والإنجليزية.
وفي الدراسة الثانية توقف أ.د. إحسان اللواتي عند "الصورة الفنية في الأمثال الفارسية"، محاولًا استخراج مصادر هذه الصورة، فتصنيفها أصنافًا، ثم بيان وظائفها التي تضطلع بها في سياق ورودها.
واستعانت د.سناء الجمالية في الدراسة الثالثة "النظم الأخلاقية في المجتمع العُماني، قراءة في نماذج من الأمثال العُمانية" بحقل الدراسات الثقافية في النقد، انطلاقًا من رغبتها في سبر أغوار فكر المجتمع العُماني من خلال فهم هويته التاريخية والاجتماعية والسياسية المتمثلة في طريقة استخدامه اليومي للّغة من خلال الأمثال المتداولة.
وفي الدراسة الأخيرة: "الإشاريات وأبعادها التداولية في الأمثال العُمانية، أمثال العمل أنموذجًا"، سعى د. زاهر الداودي إلى بيان الإشاريات الواردة في الأمثال العُمانية، وصلتها ببواعث إنتاج الخطاب ومقاصده؛ لتحقيق المنظومة التواصلية بين طرفي الخطاب.
أيام سورية في بيت الزبير
استضافت مؤسسة بيت الزبير اليوم، الفعالية الثقافية /أيام سورية في بيت الزبير/، تضمّنت عددًا من الفقرات من بينها عرض فيلم "المطران" للمرة الأولى في سلطنة عُمان، وهو من تأليف حسن يوسف وإخراج السوري فلسطيني الأصل باسل الخطيب، وبطولة رشيد عسّاف مع نخبة من نجوم الدراما السورية.
وتجري أحداث الفيلم في كابوجي شاهداً حيّاً على نكبة عام 1948، ثم يعود إلى موطنه الأصل سوريا، وبعد 17 عاماً وتحديداً عام 1965، يرجع إلى فلسطين من جديد، وتحديداً إلى مدينة القدس، ولكن هذه المرة مطراناً للروم الملكيين الكاثوليك، ويعاصر المطران مأساة الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي، لتبدأ مرحلة مهمة من حياته، ويأتي دور المطران في هذه الحقبة مزدوجاً، تارةً كان راعيا لشؤون رعيته، وتارةً مناضلاً ومقاوماً من أجل حقوق الشعب الفلسطيني.
وتتضمن الأيام السورية جلسة شعرية للشاعرين هلال السيابي ويقين جنود، إضافة إلى فقرة غنائية للفنانين: أحمد سكماني وديالا عمار والدكتورة سامية عصفور، وعلى هامش الأيام السورية يقام معرض فضاءات تشكيلية سورية وتجربة تذوق المأكولات السورية.
مكتبة عُمان الوطنية، منارةٌ ثقافيةٌ تُشرقُ على المستقبل
في قلب العاصمة العُمانية مسقط، ينبض مشروعٌ ثقافيٌّ ضخمٌ يُجسّدُ طموحات عُمان في الحفاظ على تراثها الفكريّ وتطوير منظومتها المعرفية، إنه مشروع مجمع عُمان الثقافي، الذي تحتضنُ بين جنباته مكتبة عُمان الوطنية.
تُمثّلُ مكتبة عُمان الوطنية صرحًا ثقافيًّا مهمًّا تهدفُ إلى جمعِ وحصرِ وتنظيمِ الإنتاج الفكريّ العُمانيّ بمختلف أشكاله، سواءً المطبوع أو غير المطبوع، وإتاحتهُ لجميعِ شرائحِ المجتمع.
ويقول الدكتور موسى بن ناصر المفرجي المشرف على مشروع مكتبة عُمان الوطنية إن فكرة إنشاء مكتبة عُمان الوطنية ليس وليد اليوم بل يعود إلى نهاية السبعينات من القرن الماضي، ونص المرسوم السُّلطاني 70 /77 في مادته الثانية على إنشاء المكتبة الوطنية؛ وبمواصفات عالمية تعتمد على الجانب التقني، مشيرا إلى أن مشروع مجمع عُمان الثقافي بكل مكوناته يأتي اهتمامًا من لدن صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ/، ومن المتوقع الانتهاء منه في المدة بين عامي 2027 و2028.
وأكد على أن المكتبة الوطنية بمختلف اختصاصاتها ونظامها تهدف إلى إيداع المصنفات العُمانية لحماية النتاج الفكري العُماني بمختلف أشكاله التقليديّة وغير التقليديّة.
وأشار إلى أن المكتبة ستضم كل ما نُشر عن سلطنة عُمان من إصدارات ومصنّفات ومطبوعات حكوميّة ورسائل علميّة، بالإضافة إلى المؤتمرات والندوات التي تناولت الحديث عن سلطنة عُمان.
وقال المشرف على مشروع المكتبة الوطنية إن هناك فريقًا يعمل على جمع كل إنتاج الفكر الوطني، إضافة إلى زيارة معارض الكتب ليطّلع على ما تضمه من مؤلفات ومصنّفات وكتب عن سلطنة عُمان منها، معرض الدوحة وأبوظبي ومسقط والشارقة وتونس وغيرها، كما إن الفريق قام بعدة زيارات إلى مكتبات وطنية متنوعة بأنحاء العالم منها مكتبة كوريا الوطنية، ومكتبة سنغافورة الوطنية، ومكتبة قطر الوطنية، ومكتبة محمد بن راشد، للاطلاع على تجارب الدول الأخرى.
وفي حديثه عن عدد الإصدارات التي ستضمها المكتبة الوطنية؛ أكد المشرف على مشروع المكتبة الوطنية على أن المكتبة صُممت لاستيعاب مليون مجلد، إضافة إلى المصادر الإلكترونية والوسائل السمعية والبصرية والأفلام والخرائط وغيرها.
وأشار إلى أن المكتبة ستضم مكتبة خاصة للأطفال بمبنى مستقلّ، بها مجموعات مختلفة من الكتب والمطبوعات والألعاب وكل ما يتعلق بمكتبة الطفل.
كما ستضم المكتبة الوطنية قاعات متعدّدة منها قاعات خاصة للباحثين والدارسين للاستفادة منها على مستوى البحث والتعلم مع كل ما توفره من خدمات إلكترونية، بالإضافة إلى وجود قاعات ومنصات إلكترونيّة خاصة للوسائل السمعية والبصرية تمكن الباحثون والمهتمون من الدخول إليها مصدرا للبحث والاستفادة والحصول على المعلومات المصنّفة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
ووضح أن المكتبة ستضم أقسامًا متعدّدة منها قسم المخطوطات والكتب النادرة وقسم خاص بالدراسات العُمانية والجزيرة العربية، إضافة إلى قسم خاص للدراسات المتعلقة بأئمة وسلاطين عُمان، وتوفير الخدمة المرجعية للكتب ذات الطابع الموسوعي المطبوعة وغير المطبوعة.
الهوية والمسرح في سلطنة عُمان.. بين أسس التكوين ونتائج التنفيذ
تعد الهوية الثقافية أحد العوامل الأساسية التي تشكل ركائز التعبير الفني، ويتجسد ذلك بشكل خاص في سياق المسرح بكل توجهاته، بما فيها مسرح الطفل والمسرح المدرسي وغيرها من الاتجاهات المسرحية في سلطنة عُمان، حيث تشكل تلك الهوية جوهر وجوده، وعينًا من العيون التي تسقي تراثه الغني المتنوع، هذا ما أكد عليه عددٌ من المختصين في شأن المسرح، حيث تبلور أسس التكوين ومسارات التنفيذ والنتائج المترتبة على ذلك من حيث الأدوات الممكنة.
وحول ماهية هذه الفكرة تتحدث الدكتورة كاملة بنت الوليد الهنائية الباحثة في شؤون أدب الطفل عن تأصيل الهوية الثقافية العُمانية في مسرح الطفل في سلطنة عُمان، من خلال الأسس والنتائج وتقول: المسرح ابن بيئته ويستمد جميع منابعه من المصادر التي تمدّه بالإبداع من النص والممثلين والمخرجين من الهوية التي كونتهم فلا انفصال بين ما يقدم في مسرح الكبار منه عن الذي تتم كتابته وإنتاجه في مسرح الأطفال إلا بخصوصية الجمهور المستهدف، بل على العكس مسرح الطفل العُماني تجذر في هويته، فكانت الحكايات من التراث العربي مثل حكايات ألف ليلة وليلة والحكايات الشعبية العُمانية التي استفاد منها الكُتّاب في كتابة نصوصهم والأغاني الشعبية العُمانية التي وظّفوها هي عناصر رئيسة فيما ينتج لمسرح الطفل وهي من صلب المجتمع وعمق تراثه، واستفاد مسرح الطفل من الاتكاء على جدار الهوية الصلب وأنتج بدوره مشروعات مسرحية وضعت بصمات في مسيرة المسرح العُماني.
وحول الأدوات الممكنة لذلك تشير إلى أن المجتمع متماسك في سلطنة عُمان ينقل تجاربه وتراثه للأجيال ويضع الأصالة في مقدمة تطوره ويتمسك بالقيم العليا التي تخرج في عناصر الإبداع التي يقدّمها أبناؤه في مختلف التخصّصات، وكان لمسرح الطفل نصيب وافرٌ من هذه الاجتهادات حسب الدراسات؛ فعلى سبيل المثال في كتاب (مسرح الطفل في عُمان) وجدت زيادة في النصوص المكتوبة والعروض المقدمة من الفرق المسرحية الأهلية، فكما تنفتح الفرق المسرحية على التطورات التقنية لكنها تستند على الهوية العُمانية المميزة في رسائلها ومعانيها التي توصلها لجمهور الأطفال.
وعن إمكانية أن تكون الهوية الثقافية في مسرح الطفل أداة تحصين في ظل الانفتاح على العوالم الثقافية؛ وضحت أنه لا يمكن إنكار أن أطفالنا مستهدفون من هويات عابرة للحدود، وهذا التحدي يكبُر يومًا بعد آخر.
وفي ظل عدم وجود (هيئة عُليا للمرأة والطفل) مهمّتها الرئيسة تأكيد الوعي الثقافي والفكري والفني، كما أن المؤسسات الحالية مهمّتها الجوانب الاجتماعية والدّعم المعيشي، فيتحتّم حينئذ وجود برامج فنية ذات إنتاج محترف تسهم في تعزيز القيم الرفيعة والهوية الأصيلة والأخلاق العالية.
ويعد مسرح الطفل الذي يقوم بأدوار كثيرة في هذا المجال مدرسة بحدّ ذاته، ونطمح أن يكون هناك مهرجان وطني لمسرح الطفل، ويختار شعار في إحدى دوراته العبور بالهوية إلى عصر الذكاء الاصطناعي، فالأطفال هم مستقبلنا فمثل هذا الربط بين التطورات التقنية في هذا العصر وما يقدم لهم من مادة فنية تثقيفيّة وترفيهيّة وربطها بالهوية الوطنية تزيد من التمسّك والفخر والاعتزاز بهذه الكنوز الرفيعة التي نملكها في سلطنة عُمان.
ولا يبتعد الكاتب والمخرج المسرحي المغربي عبد اللطيف فردوس الذي كان قريبًا من المسرح العُماني في برامج شتى عندما يقدم رؤيته حول الهوية في المسرح العُماني ومدى تأصلها وتأثيرها في الواقع الثقافي، وهنا يشير إلى أن الهوية الثقافية تعدّ أحد العوامل الأساسية التي تشكل ركائز التعبير الفني، ويبرز ذلك بشكل خاص في سياق المسرح العُماني، حيث تشكل جوهر وجوده، وعينًا من العيون التي تسقي تراثه الغني المتنوع، فالمسرح العُماني أداة فاعلة للاستكشاف والتعريف بالهوية العُمانية بشكل عام، فهو يتغذّى وفي الوقت نفسه يغذّي بشكل نسقي تفاعلي قيم ومعارف الإنسان العُماني النوعية، وينهل من تقاليده وعاداته الأصيلة المتعدّدة التي تميز المجتمع العُماني، وتمثل مصدر إلهام للمسرحيين كُتّابًا ومخرجين ومصممي المناظر والملابس والاكسسوارات وملحني كلمات الأغاني المسرحية.
ويشير إلى أن تأصل الهوية في المسرح العُماني تعود جذوره إلى العوامل التاريخية والاجتماعية والثقافية، وتبرز ثماره من خلال الاستعانة بالتراث الشعبي والتاريخ الوطني، حيث ركز المسرح العُماني وما يزال الضوء على قصص وشخصيات وأحداث ومواقف وبطولات وملحمات تعكس هوية هذا الشعب الظاهرة- الزاهرة، وروحه العتيقة- الأنيقة، ويكفي أن نلقي نظرة على العروض المسرحية وعلى النصوص المكتوبة والدراسات التي تناولت المسرح، والكتابات النقدية لنأتي بما لا يحصى من التأكيدات والشهادات والأدلة، ولا أرى أن الأمر يحتاج إلى ذلك، لنخلص إلى أن المسرح العُماني عامل أساسي في تعزيز الشعور بالانتماء والفخر بالهوية العُمانية، ومع ذلك، فالهوية في المسرح العُماني ليست كيانًا ثابتًا، بل تتطور وتتغير مع تطور المجتمعات والتحولات الاقتصادية والثقافية والسياسية؛ ولم يبقَ المسرح في تعامله جامدًا ولا متفرجًا، بل انخرط في هذا التحول بشكل إيجابي إيمانًا منه بأن الحاضر يرسم للأجيال المقبلة هويتها، لذلك يعمل المسرحيون من ممارسين وأكاديميين وسلطات عليا، على الإسهام في تشكيل الهوية الوطنية المستقبلية، التي يظهر من مساراتها الحالية ووسائلها التكنولوجية التي تتطور باستمرار، أنها ستصبح هوية كونية، يفقد البوصلة فيها، ويفقد ملامحه أي شعب لم يبصم هذا التحول الكوني بخصوصياته المحلية المتأصلة، وبمرجعياته الثقافية، ما يحمّل المسرح مسؤولية كبرى في تعاطيه مع موضوع الهوية.
ويختتم حديثه: عمل المرحلة وشعارها واستراتيجيتها "لا للانفتاح المطلق، ولا للتحجر المتعصب ولا للشوفينية الضيقة". هذا ما يؤمن به المسرحيون في سلطنة عُمان، وهذا ما خلصت إليه من خلال احتكاكي مع بعضهم، سواء بطريقة غير مباشرة، عبر الكتابات وما يعرض في مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال اللقاءات المباشرة في المهرجانات الفنية، ومن خلال زياراتهم للمغرب، وكذلك من خلال زيارتي لسلطنة عُمان وخاصة مسقط ونزوى، وهذا ليس بغريب على شعب خبر الأصالة ومارس الانفتاح الواعي منذ أزمنة بعيدة في تاريخه العريق الحافل. فسلطنة عُمان كانت على الدوام شجرة فروعها متجذرة وفروعها باسقة عالية متطلعة، مثمرة وسخية، يعمل المسرح فيها دون مهادنة ولا هوادة على تعزيز التواصل الثقافي والفهم المتبادل بين الشعوب ويسهم في تعزيز التسامح والاحترام المتبادل بين الثقافات المختلفة.
أما الدكتورة عزة بنت حمود القصابية باحثة في شؤون المسرح العُماني فتتحدث في هذا السياق عن ترسيخ الهوية الثقافية الأدبية في الأعمال التي نراها ظاهرة على خشبة المسرح العُماني، والأساليب المتبعة لعملية الترسيخ وتقول: لابد من الاعتراف بأن المسرح العُماني هو من منظومة المسرح الخليجي، هذه الكتلة المتقاربة جغرافيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وتاريخيًّا، لذلك فإن بدايات المسرح الخليجي جاءت متقاربة في السمات العامة، عندما انطلقت من المؤسسات التربوية من خلال الأنشطة التي تقام في كل عام، وتتضمن باقي الأنشطة مثل الإلقاء والإنشاد والموسيقى والفنون الجميلة.
وتضيف: المسرح العُماني في بداياته لم يُعرف بصفته فنًّا، ولكنه كان جزءًا من النشاط الثقافي، والتراثي والتاريخي، ورافق المسيرة التربوية ما بعد سبعينات القرن الماضي، وما قبل ذلك كان من خلال المدارس السعيدية الثلاث، وحدثت النقلة النوعية للمسرح العُماني ما بعد ثمانينات القرن الماضي، عندما بدأت تترجم الأعمال المسرحية العالمية، وتعمين وإعداد بعض المسرحيات العربية، وتشكيل أول فرقة مسرحية، ثم سرعان ما بدأ الكُتّاب العُمانيون في كاتبة نصوص تحمل روح وهوية الشارع العُماني بما فيه من قضايا وموضوعات تستحق أن تطرح على خشبته، وكان للمسرح جمهوره الذي يحرص على التفاعل مع عروضه البسيطة .
وتوضح أنه بمرور الزمن، توالت العروض المسرحية العُمانية التي وثقت للمسرح العُماني، وبرزت من خلالها الهوية الثقافية، وخاصة العروض الجماهيرية، وتلك المستوحاة من التراث العُماني ومن التاريخ العُماني.
وعن آليات الترسيخ تقول: إن معالجة الأعمال المسرحية أولًا لقضاياه الحاضرة والتفاعل مع الشارع العُماني، ومحاولة تقديم عروض عُمانية تعبر عن رأيهم، وتجعلهم يتعاطفون معها، فهذه الموضوعات وسيلة المسرح لاستقطاب الجمهور، الذي يشكل القطب الثالث في عملية التواصل والاتصال مع العروض المقدمة، وهناك الكثير من الأعمال المسرحية وكذلك السينمائية التي استوحيت حكاياتها من القصص الواقعية، وعرضت بعد إعادة كتابتها في قالب مسرحي أو تلفزيوني،
وسبق أن أشرت إلى أن بعض العروض حرصت على ترجمة التراث العُماني، وإعداده على هيئة عروض مسرحية، مستوحاة من التراث، لتشمل الفنون المغناة، والراقصة والاستعراضية والفنون الأدائية الشعبية على هيئة مقاطع تمثيلية، يمكن تطويرها وبالتأكيد ذلك يعزز ويُرسخ الهوية العُمانية الثقافية.
وأضافت أنه عند التأصيل لمسرح عُماني، أو لأي فن من الفنون الإبداعية، سنجد الهوية الثقافية فيه مطلب أساسي، وهي عنوان وشعار نعتز به، أما فكرة استضافة عروض مسرحية لا علاقة لها باهتمامات الإنسان في سلطنة عُمان، فلا تضيف أي جديد، لذلك من الضروري توظيف مفردات البيئة العُمانية لصنع خصوصية وهوية وطنية تشمل مقومات وخصائص تنفرد بها عن الثقافات الأخرى، لذلك علينا أن نسخّر كل مؤسساتنا الثقافية والفنية لصناعة الهوية العُمانية في كافة المجالات الإبداعية البصرية والكتابية والفنية مثل المسرح والاستعراض الفني والغناء المعبر عن مفردات وعناصر الهوية العُمانية، أما الثقافة العالمية فهي إرث مشاع، ولا يتقيد بالخصوصية.
أما المسرحي بدر بن سيف النبهاني فيتطرق إلى تجسير واقع الهوية العُمانية والتواصل الثقافي بين الأجيال من خلال المسرح المدرسي في سلطنة عُمان، والأدوات الناجعة للعمل عليها وتحقيق نتائج إيجابية تتعلق بشأن هذا التجسير، ويقول: منذ عقود من الزمن ونحن نتحدث عن التداعيات التي خلفتها وتخلفها العولمة باعتبارها واحدة من أهم الظواهر الحضارية من جهة وكونها ظاهرة تؤثر على هوية الإنسان وتجعله نسخة مشابهة للإنسان الآخر في مختلف أبعاد حياته، ما يلقي بظلال قد تكون خطيرة على مستقبله.
ويضيف أنه على الرغم من أن للعولمة جوانب إيجابية ظاهرة من قبيل سهولة التواصل، وسرعة التعلم، والوصول إلى أي معلومة بيسر وسهولة، وقياسًا على ذلك الوصول إلى المهارات التي باتت الشغل الشاغل لكل البشرية، إذا ما سلّمنا بأن العالم الحديث يعتمد على المهارة أكثر من المعلومة ذاتها على مختلف الأصعدة، فمن يملك مهارة البحث عن المعلومة بسرعة وبطريقة صحيحة بات في منزلة أفضل من ذلك الذي يحفظها على سبيل المثال، إلا أننا بتنا نشاهد نسخًا مشوهة نتيجة التقليد المبتذل لكل ما هو جديد وإن كان مخالفًا لثوابت لدى الإنسان تقوم عليها هويته التي تميزه عن الآخر، ما يجعله نسخة مشوهة عن آخر لربما لم ينشأ في بيئة صحية سليمة، إن هذا التقليد والرغبة في التشبه بالآخر على الرغم من أنه مخالف لهوية الإنسان؛ ينذر بمشكلة تتفاقم بشكل سريع ما يجعل التربية تواجه تحديات صعبة تحتاج لمواجهتها هذه أن تستخدم كل الأدوات والوسائل والطرق المؤثرة في النشء للعودة بهم إلى الاعتزاز بالهوية العُمانية وتقديمها بشكل لائق ومتوافق مع روح العصر الحديث.
ويؤكد أنه مما لا شك فيه أن المسرح المدرسي واحدة من هذه الأدوات الفاعلة، لإيماننا الشديد بأن المسرح أقوى القنوات الثقافية المؤثرة على الإنسان على مر العصور، وبما أن جميع المدارس العُمانية تفعّل المسرح المدرسي كنشاط طلابي فإن هذه الأداة لربما تكون رائدة الأدوات التي من الممكن للمؤسسة التربوية مكافحة التأثيرات السلبية للعولمة من خلالها، وأن التاريخ العُماني يزخر بقصص الأبطال والملاحم التاريخية التي سطرها العُمانيون على مر العصور، ولا شك أن تقديم هذه النماذج القريبة للغاية من تكوين الطالب العُماني سيكون أكثر تأثير وأقرب للذهن، لكن الذكاء سيكون في كيفية تقديم هذا الموروث بصورة عصرية تنسجم مع عقلية هذا الجيل الذي يقضي وقتًا طويلًا خلف شاشات الهواتف المحمولة وغيرها.
ويوضح أنه على الرغم من حساسية الحديث عن عصرنة الموروث، وضرورة توخي أقصى درجات الحذر عند الشروع في ذلك، إلا أن هناك الكثير من العصرنة على الأزياء والموسيقى على سبيل المثال، كما يجب تقديم الهوية بروح عصرية من خلال المسرح المدرسي، بما يضمن قبول النشء لها وتمثلهم إياها بروح عصرية.
ويلفت إلى أن ما يميز المسرح بصفته فنا عن باقي الفنون أنه جامع لها، وهذا ما دفع إلى تسميته بأبي الفنون، فتجد تكاملًا بين النص والفن التشكيلي، والموسيقى التصويرية، والإضاءة، وتصميم الأزياء وغيرها الكثير من الفنون التي تجتمع لتتكامل وتقدم عرضًا مسرحيًّا غايته التأثير بشكل ناجح لتحقيق الوعي المنشود بالقضايا المصيرية للإنسان في أي مجتمع، والتفكير في تكامل هذه الفنون لتعزيز الهوية العُمانية لدى النشء وليس ذلك بأمر مستحيل إذا ما آمنا بأن الموروث ذاته لم يكن على شكله الأخير حينما وصل إلينا، فبلا شك أن الأزياء قد مرت بالكثير من التطورات بعضها كان ضرورة والآخر كان بغرض التجميل ومواكبة العصر.
وأكد على أن طبيعة الحياة التي يعيشها الإنسان في سلطنة عُمان دفعت إلى تطوير زيّه بكل تأكيد، ومن الممكن أن يقاس ذلك على باقي المكونات المتأثرة بشكل أو بآخر بمؤثرات تجعلها تتطور، فالموسيقى العُمانية تأثرت بموسيقى السواحل الأفريقية، ولا غرابة في أن نسمع فنًّا عُمانيًّا بحريًّا، كلماته تكون بلغة سواحيلية أو غيرها من اللغات.
وقال إن الإيمان بمبدأ أن الحياة تتطور والهوية باقية لكنها توائم هذا الإنسان وتميزه ولا تلغيه بل تعزز وجوده وتفرده، يجب القبول به إذا ما أردنا أن ننجح في استخدام أدوات تتسم بالتأثير في العمل المسرحي المدرسي، وأن فكرة التأثير وبث روح التمسك بالهوية العُمانية لا يمكن أن تقع على عاتق المسرح المدرسي ومسرح الطفل فحسب، بل يجب أن يكون هذا الأمر مشروعًا ضخمًا تشترك فيه الكثير من المؤسسات، وأن المسرح بشكل عام والمسرح المدرسي بشكل خاص أحد هذه الأعمدة التي قام عليها هذا التغيير، وذلك نظرًا إلى كون الطالب في هذه المرحلة في طور تشكّل لبنات شخصيته الأولى، والتأثير عليه أسهل بكثير من التأثير عليه في مراحل أخرى.
ــــــ
م.ع
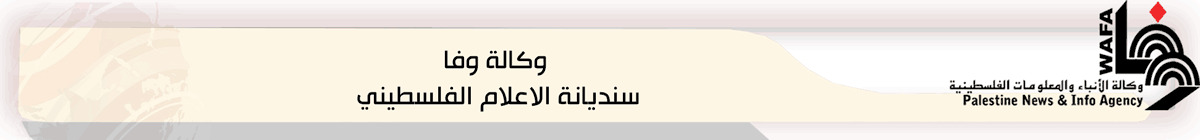
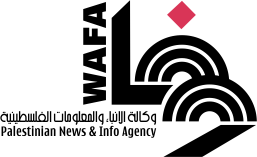

.jpeg-87fbf279-a0d4-4cd9-b77c-7903c423d7c7.jpeg)








